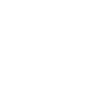بوضوح
في عالم يتسارع إيقاعه، وتتشابك فيه الأحداث والمرويات، يغدو التوثيق فعلاً حضارياً لا غنى عنه؛ فهو ليس مجرد تسجيل للأحداث، أو تخزين للمعلومات، بل ممارسة واعية لحفظ الذاكرة، وصيانة للهوية، وتأصيل للمعرفة.
فالأمم التي تحفظ أرشيفها، وتحسن رواية قصتها، تضمن لنفسها حضوراً متماسكاً في وعي أبنائها، وفي سجل الإنسانية.
في السياق الكويتي، لا يزال التوثيق يعاني من ثغرات واضحة، سواء على مستوى التوثيق المؤسسي أو الفردي.
فكم من مبادرات ريادية، وتجارب تطوعية، وإنجازات رياضية، ووقائع تاريخية، ضاعت، أو شُوّهت، لغياب الرواية الدقيقة، أو انعدام التوثيق المهني، والأسوأ حين يُترك الحفظ للذاكرة الشفهية، أو التقدير الشخصي، ما يفتح الباب للتحريف أو النسيان أو التوظيف الانتقائي؟
تتجلى أهمية التوثيق في قيمته المعنوية والمعرفية؛ فهو يمنح أصحاب الإنجاز الاعتراف، ويمكّن الباحث من التحليل، ويوفّر للمجتمع مرآةً لتقويم مساره.
كما أن أثره على الأجيال القادمة لا يُقدّر بثمن، إذ يربطها بجذورها، ويمنحها سردية وطنية ناضجة، ويمنع اغترابها عن سياقها.
لكن التوثيق لا يخلو من تحديات؛ منها غياب ثقافة التوثيق في المؤسسات، وقلة الكفاءات المتخصصة، وغياب المنهجية، وتضارب الروايات.
وهنا تبرز الحاجة لوضع معايير وطنية للتوثيق، وتشجيع مبادرات الأرشفة الرقمية، وإدراج التوثيق ضمن خطط العمل المؤسسي، خصوصا في المجالات التي تعاني من ضمور التوثيق، مثل الرياضة والمجتمع المدني.
إننا بحاجة إلى رؤية وطنية تجعل من التوثيق أولوية، لا ترفاً، وأداة بناء لا رفّ أرشيف. فكما أن الدول تقاس بإنجازاتها، فإن استدامة هذه الإنجازات تبدأ من حفظها، والتوثيق هو أول خطوة في هذا الاتجاه.
***
نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الأمير، وسمو ولي العهد حفظهما الله.
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار.