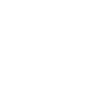عندما حذّر توم باراك، المبعوث الأميركي إلى سورية، من أن لبنان قد "يعود إلى بلاد الشام"، لم يكن تصريحه مجرد زلة لسان، بل بدا
كأنه اختبار لمدى قابلية هذا الطرح للتداول العلني.
صحيح أنه سارع لاحقاً إلى التراجع، لكن التصريح أدّى غرضه. فبعض الكلمات حين تصدر من ديبلوماسي رفيع في سياق أزمات مستمرة، فإنها تُقرأ كإشارة مقصودة لتوسيع دائرة النقاش، لا كجملة عابرة. والتراجع في مثل هذه الحالات لا يُلغي الفكرة.
هذه التصريحات مؤشّر على تحوّل عالمي في فهم السيادة؛ فما كان محرّماً بالأمس، بات اليوم مطروحاً للنقاش. والتاريخ يعلّمنا أن التحوّلات الكبرى لا تبدأ بالضرورة بالدبّابات، بل بالكلمات. ويكفي أن يُطرح الضمّ علناً، حتى تهتزّ فكرة الحصانة، ويغدو الكيان المصون موضوعاً للتفاوض.
فما الذي يمنع الدول القويّة من اعتبار أمن جيرانها امتداداً لأمنها القومي، وما الذي يحول دون التمهيد لضمٍّ ناعمٍ تحت ذرائع من قبيل الاستقرار، أو الوحدة، أو الحماية؟
وحين يُصبح هذا النقاش مشروعاً، تُصبح كل دولة صغيرة مهدّدة بالتحوّل من كيانٍ مستقل إلى ورقةٍ تُتداول على طاولة الترتيبات الكبرى.
قد يستهين البعض بهذه الأسئلة. لكن يكفي النظر إلى النزاع في الصحراء الغربية، والتوتر في كشمير، وتصاعد الحديث عن عمل عسكري صيني ضد تايوان، ووجود مناطق نفوذ باكستانية وإيرانية في أفغانستان، فضلاً عن المشهد السوري الذي يُظهر بوادر تقسيم فعلي غير معلن.
قد يرى البعض أن الشرعية الدولية والتحالفات القديمة تكفي للحماية، لكنّها لم تعد ضماناً مطلقاً في عالم يتغيّر فيه ميزان القوة وتُعاد فيه كتابة قواعد السيادة.
والمفارقة أن الدول التي تضع أُسس النظام الدولي وتوقّع على اتفاقيات السلم والحماية، كأميركا وروسيا والصين، هي نفسها من يقود التحوّل نحو منطق الضمّ والاستحواذ، ولو بأدوات قانونية.
وهذا يفتح سؤالاً: كيف يُفترض بالعالم أن يحتمي بمن يتبنّى منطق التوسّع؟
وحين تكون القوى الراعية للنظام الدولي هي أول من يتجاوزه، فإن الدول الصغيرة لن تجد أمامها نظاماً يحميها، بل منظومة تتغيّر قواعدها بتوقيع الأقوياء.
وما يزيد المشهد خطورة هو وجود لاعب لا يؤمن له جانب، إسرائيل التي تُتقن استغلال التحولات، وتتحرك خارج كل الحسابات التقليدية، بوصفها الفاعل الأخطر والأكثر تأثيراً في معادلات الشرق الأوسط.
ويكفي النظر إلى ما جرى قبل ايام حين شنّت إسرائيل ضربات جوية مكثفة على مواقع حساسة في قلب العاصمة السورية دمشق، بما في ذلك منشآت عسكرية وأمنية، وأوقعت عشرات الضحايا. لم يكن الهدف احتلالاً مباشراً، بل إعادة رسم المشهد الأمني والسياسي عبر ضمّ وظيفي ناعم، تُعيد فيه إسرائيل تعريف مفهوم "التدخّل الوقائي".
ما جرى في السويداء ترجمة حيّة لمنطق التوسّع الجديد. اختراقات تتسلل باسم الحماية، ثم تُترجم ميدانياً إلى نفوذ مستدام. وهنا تكمن خطورة إسرائيل لا فقط في سلوكها، بل في قدرتها على فرض واقع جديد دون أن تضعه على طاولة المفاوضات أصلًا. فالخرائط لم تعد تُعدّل بالمعاهدات، بل بالصواريخ، ومن يملك طيرانًا بلا ردّ يُصبح شريكًا في هندسة الجغرافيا. وهذا يضع دولاً كثيرة ضمن دائرة الترقّب…إن لم يكن دائرة الخطر.
ما الذي ينبغي على الدول فعله؟
أولاً، عدم الركون إلى الاطمئنان الزائف، بل بناء سياسة خارجية متوازنة تجمع بين الحذر والانفتاح. فالرهان على الاستقرار دون استعداد هو مجازفة.
وثانياً، تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، لأن التهديدات الخارجية لا تنجح إلا حين يكون الداخل هشاً أو منقسماً.
ليس المطلوب أن نبالغ في القلق…لكن الخطأ هو أن نتعامل مع هذه المؤشرات وكأنها لا تعنينا.
كل دولة صغيرة أو متوسطة الحجم مطالَبة اليوم أن تطرح على نفسها سؤالاً صريحاً: ما الذي يجعلها عصيّة على أن تكون مشروع ضمّ في يوم ما، وما الذي يمنحها مناعة فكرية وسياسية، تجعل اسمها غائباً عن مثل هذه الطروحات؟
@Abdulaziz_anjri