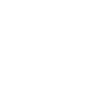وجهة نظر
يُعد التظلم أحد الضمانات الجوهرية لحماية الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية، إذ يُمكّن صاحب الشأن الطعن دون اللجوء مباشرة إلى القضاء، مما يحقق مبدأ التدرج في التقاضي، ويخفف العبء عن المحاكم.
وفي الكويت، نظّم المشرع هذا النظام بموجب المرسوم رقم 20 لسنة 1981، إذ أنشأ دائرة متخصصة في المحكمة الكلية للفصل في المنازعات الإدارية، وأفرد المادتين السابعة والثامنة من القانون لبيان إجراءات التظلم والطعن. من أبرز الإيجابيات التي لا يمكن إغفالها أن المشرع حدّد ميعاداً واضحاً للطعن، وهو 60 يوماً من تاريخ تحقق العلم اليقيني بالقرار، وهذا العلم لا يُفترض إلا إذا تحقق لصاحب الشأن إحاطة كاملة بعناصر القرار، بما يمكنه من إدراك مركزه القانوني بدقة.
وقد اشترط المشرع إثبات العلم بشكل مؤكد، ويقع عبء الإثبات على الجهة الإدارية، وفي حال عجزها، يظل ميعاد الطعن مفتوحاً. وهذا المبدأ يُعد ضمانة قوية لحقوق المتضررين، ويمنع تجاوزات الإدارة التي قد تتعمد تأخير أو إخفاء الإخطار.
غير أن الجانب الإجرائي المتمثل في مفهوم "العلم اليقيني" يثير إشكالات قانونية وعملية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقرارات الفردية. فبينما يُعتبر النشر في الجريدة الرسمية أو نشرات الجهات الحكومية وسيلة مشروعة للعلم بالقرارات التنظيمية، يُشترط في القرارات الفردية إخطار أصحاب الشأن بها مباشرة.
لكن في الواقع، قد تتأخر الإدارة في الإخطار، أو لا تؤديه أصلاً، مما يؤدي إلى نزاع حول تاريخ بدء سريان مدة الطعن. وهذا يفتح المجال لتأويلات قد تضر بمصلحة المواطن، وتُستخدمها الإدارة كوسيلة للتهرب من الرقابة القضائية. وفي ما يتعلق بإجراءات التظلم، فقد ألزم القانون مقدم الطلب بالتوجه أولاً إلى الجهة التي أصدرت القرار، أو إلى الجهة الرئاسية للتظلم، قبل اللجوء إلى القضاء، على أن ينتظر المدة المقررة قانوناً للبت في التظلم. وإذا لم تتجاوب الجهة الإدارية خلال هذه المدة، اعتُبر سكوتها بمثابة رفض ضمني، وهو ما يُعرف بالرفض الحكمي.
هذا الأسلوب القانوني يحمل في طياته بعض الإشكاليات، إذ إن اعتبار السكوت بمثابة رفض لا يُراعي حق المواطن في الحصول على رد صريح ومسبب، مما يفقد التظلم معناه كآلية فعّالة لحل النزاع بطريقة إدارية سلمية.
كذلك، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى تنظيم إجراءات التظلم بشكل أكثر تفصيلاً، سواء من حيث طرق التقديم، أو المدد المحددة للرد، أو آلية متابعة الطلب، بالإضافة إلى أن النص على أن "مرسومًا يصدر لتوضيح الإجراءات" دون صدور هذا المرسوم بوضوح في الواقع العملي، يترك فجوة تشريعية تعطل الاستفادة الحقيقية من حق التظلم، وتخلق حالة من الغموض القانوني لدى الأفراد.
وفي ضوء ما سبق، يظهر أن النظام الكويتي قد خطى خطوات تشريعية متقدمة نحو تنظيم التظلم الإداري، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير في الممارسة العملية، وتفعيل الرقابة على الجهات الإدارية، وتحديث التشريعات بما يضمن تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة.
كما ينبغي إعادة النظر في القواعد المتعلقة بالعلم بالقرار والرفض الضمني، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان استقرار القرارات الإدارية.
مشعل أحمد حامد الفضلي
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون