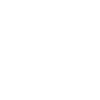تعمل الدول على تطوير بناها التحتية كي تضمن الاستقرار الاجتماعي عبر تحريك العجلة الاقتصادية، وهذه تخلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويؤدي إلى الازدهار المحلي، وكلما كانت البنية التحتية متطورة تصبح عامل جذب استثماري أجنبي ومحلي.
ولأن الشريك الطبيعي للقطاع العام هو القطاع الخاص، فإن الأول يعمل على منح الثاني مساحة أكبر من المحفزات حتى تصبح الشراكة ذات منفعة مشتركة.
لهذا، فإن المشاريع الكبرى في الدول، لا سيما المتصلة بالبنية التحتية، كالمترو، وشبكة القطارات، والطرق السريعة، وحتى الإنشاءات الصحية والتربوية، وغيرها مما يخدم التنمية المحلية، تكون ضمن اتفاقات طويلة الأجل، ومستقرة، وتتضمن تسهيلات كبيرة للشركات المنفذة، أكانت محلية أو أجنبية، بل إن الأخرى تكون لديها شروط ميسرة جداً، لأنها أولاً تستثمر أموالها في الدولة، وثانياً تعمل على الاستعانة باليد العاملة الوطنية.
هذا ما هو معمول به في غالبية دول العالم، إذ تكون المشاريع التنموية عبر نظام "بناء، تشغيل، تحويل" (B.O.T) لإشراك القطاع الخاص في التنمية، عبر امتياز يكون على فترات طويلة، ويمكن أن تصل إلى نحو 50 سنة أو أكثر.
عندنا يبدو الأمر غير ذلك، إذ بدلاً من تشجيع القطاع الخاص، كشريك في التنمية، تعمد جهات حكومية إلى عرقلة مشاريعه المنتجة، عبر قرارات تؤدي إلى الحد من نشاطه، كتلك التي صدرت أخيراً بالنسبة إلى القسائم الصناعية والزراعية والخدماتية، وهي مخالفة لكل بيانات مجلس الوزراء بشأن تشجيع القطاع الخاص، بل أكثر من ذلك، فهي تسهم في زيادة التضخم جراء محدودية المنافسة.
في غالبية دول العالم هناك شركات محلية أو أجنبية تشيّد مطارات، وسكك الحديد، وتشق الطرق، وتمولها، ومن ثم تسترد أموالها من خلال نظام المنفعة المتبادلة، وبذلك لا تتكلف الدولة شيئاً، ولا حتى تقع تحت العجز المالي، كما أن الشركات تحصل على بيئة استثمارية داعمة وحوافز وتكون أعمالها مستقرة، بينما تحقق الحكومات تنمية مستدامة.
هذا ما نراه في الإمارات والسعودية وغيرهما من الدول المجاورة، التي نفضت عنها عباءة احتكار الدولة كل شيء، بعد أن رأت في ذلك ما يجعل الاقتصاد المحلي محدود الإمكانات، وبالتالي يصبح على المدى الطويل طارداً للاستثمار، المحلي والأجنبي، كما أنه يزيد من الاتكال على موارد الدولة المحدودة أصلاً، ولا يساعد على تنويع مصادر الدخل.
في الفترة الماضية كانت هناك قرارات لا تساعد على الاستقرار التنموي محلياً، لأن الاشتراطات المزعجة التي وضعت أمام القطاع الخاص، لا سيما ما يتعلق بالقسائم الصناعية والخدماتية والزراعية، جعلت الجميع يشعرون بالقلق، فيما المطلوب محفزات وإغراءات لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في السوق المحلية.
من الطبيعي أن ذلك يجعل أصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن بيئات أكثر استقراراً، وفيها تسهيلات كبيرة. فعلى سبيل المثال، نحن نسمع منذ نحو ثلاث سنوات عن الشراكة الصينية - الكويتية، وإلى اليوم لم نر أي إنجازات يمكن التعويل عليها، أو هي بطيئة.
لهذا، يمكن القول: إن ما يجري لدينا عكس ما هو معمول به في العالم، إذ يكون المطلوب من المستثمر أن يقدم إغراءات للدولة، وليس العكس، لذا يبقى السؤال: من الذي يحتاج إلى الآخر، ومن الساعي إلى جلب الاستثمارات الاجنبية؟