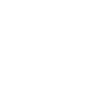ليست المؤسسات المجتمعية، ولا الفرق التطوعية أو الجمعيات الخيرية والمهنية الأهلية أو التعاونية، أذرعاً مضافة إلى جسد الدولة، إنما هي عروق تغذي المجتمع ويستمد منها حياته واستدامته. أقول هذا الكلام لأن أصواتاً تتساءل أحياناً عن جدوى وجودها لأن من الخطأ - كما أتصور- أن يُختزل الحديث عنها في معادلة حسابية تزن وجودها بعددها، لا بأثرها، أو تفترض أن الحل في تقليصها أو دمجها، وكأن المجتمع يشفى بالتقليل من عافيته.
في منطق التنمية المستدامة، لا يُقاس التقدّم الذي يمكن قياسه لا بكمّ المؤسسات، إنما بقدرتها على تحويل الاحتياج إلى فرصة، والعبء إلى قيمة.
لذلك أرفع صوتي، وأوجه ندائي لكل ما يعنيه الشأن العام إلى التحول نحو "الاستدامة المجتمعية"، وهي كما أفهمهما إعادة هندسة المنظومة المجتمعية، وحوكمتها لتكون- متى أحسنّا استثمارها- أحد أهم روافع التوازن بين الدولة والسوق والمجتمع، وهي أداة لصون الاستقرار الاجتماعي، بوصفه ركيزة في الأمن الإنساني لا ميداناً للإحسان الموسمي. إن الدعوة إلى التقليص أو التهميش تحت ذرائع تتهاوى عند أدنى محاججة منطقية، كونها تتجاهل أن هذا القطاع لم يعد قطاعاً معزولاً عن حركة التنمية، بل أصبح فاعلاً في الاقتصاد الاجتماعي، وشريكاً في حماية النسيج الوطني، ومختبراً للتكافل الذكي الذي يُسند الدولة في أوقات العزلة أو الشدة، ويواكبها في مسارات التحول والازدهار.
إننا في حاجة إلى توسيع مفهوم الاستدامة المجتمعية: من متطوع عامل إلى فريق فاعل، ومن مبادرة تنمو إلى جمعية تسمو، تتكامل الجهود نحو منظومة أثرٍ مستدام.
هذا التحوّل لا يُنجزه العدد بل الامتياز - امتياز في الحوكمة، وفي الكفاءة، وفي الوعي بالتحولات الوطنية والإنسانية. لقد علّمتنا التجارب أن المجتمعات التي تضعف فيها شبكات العطاء الطوعي، تضعف فيها المناعة الاجتماعية، فالجمعيات ليست طرفاً في المعادلة، بل هي نقطة الاتزان، وحين تضعف يختل البناء وتتفاقم الضغوط والأزمات.
لذلك فإن منطق المرحلة يفرض علينا أن ننتقل من جدل "كم جمعية نحتاج"؟ إلى سؤالٍ أعمق: كيف نجعل كل جمعية قادرة على الصمود، وتمكينها بما يليق بمستقبلنا ورفاه أجيالنا، بما يضمن تعظيم حضورها في مشروع الاستدامة المجتمعية، حيث تتكامل الإرادات، وتتّسع الرؤية، ويصبح العطاء رافداً للتنمية لا عبئاً عليها؟
خبير استدامة