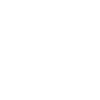وصلت معدلات التضخم عالمياً إلى مستويات حرجة، وباتت تؤثر في الاقتصادات كافة، ولهذا، فإن ثمة دولاً لديها القدرة على المواجهة، لأنها اتبعت سياسات حصيفة، فهي لم تتأثر بذلك، بل إنها رفعت ناتجها الوطني، وخفّضت معدل التضخم الداخلي.
في الوقت نفسه، إن هذه الدول تستعين بثروتها الوطنية لتعزيز القدرات كافة في مجالات الاقتصاد المحلي، وتوسيع المشاركة مع دول لديها اقتصاد مشجع.
على هذا الأساس، يمكن النظر إلى دول "مجلس التعاون" الخليجي حالياً على أنها البيئة الفضلى للاستثمار، نتيجة عوامل عدة، منها الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وكذلك الحرية الاقتصادية، وفتحها الأبواب أمام المبادرين من شتى دول العالم.
من هنا، فإن القرارات والقوانين التي صدرت في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعُمان، والبحرين وقطر كلها تصب في تشجيع الاستثمار الأجنبي، وكذلك المحلي، بل أكثر من هذا، فهي عملت على توطين رؤوس الأموال من خلال منح جنسيات وإقامات دائمة، وذهبية وغيرها، ما يجعل المستثمر يشعر أنه في بلده، وليس مهدداً دائماً.
إن هذه الإجراءات كانت حصيلة لكثير من الدروس المستفادة، لا سيما الحرب العالمية الثانية، وكيف عملت الدول المحايدة على فتح قنوات مالية وتجارية مع الدول المتحاربة، وقد خدمت الاقتصاد العالمي حينها عبر استمرارها في التجارة مع الأطراف المتحاربة، ما أدى إلى تدفق السلع الأساسية والمواد الخام إلى كلا الجانبين.
هذه النتيجة أخذتها بعض الدول حالياً كنموذج لأي أزمة عالمية مستجدة، لا سيما بعد أزمتي العام 2008 المالية العالمية، وجائحة "كورونا"، وعملت على خلق مجالات يمكنها من خلالها أن تحافظ على استقرارها لسنوات، بل لعقود عدة، لأن الهدف ليس اللحظة الحاضرة، إنما مستقبل الدول والشعوب قوتها في مواجهة أي أزمة.
صحيح أن الدول تعالج التضخم بفرض الضرائب والرسوم، لكن هذا لا يكفي، فكما هو معروف أن أساس الاقتصاد الاستمرارية لأنها عامل من عوامل قوته، والركن الأساسي في الاستقرار الاجتماعي، لهذا فإن الإدارات الحصيفة تعمل على جذب الاستثمارات عبر سياسات رشيدة لتحسين الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والإنتاج الزراعي، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات المستجدة.
إن كل هذا يساعد على الإنفاق العام في المشاريع الكبرى، وكذلك الخاص "الاستهلاك الفردي"، خصوصاً إذا كانت الدولة لديها ثروة، ودول الخليج العربية لديها كل هذه الإمكانات، وكما أسلفنا فهي تستفيد من ذلك بأقصى طاقتها، وتعزز قوتها الاقتصادية عالمياً.
بعد هذا العرض، ماذا عن الكويت، وهل استفادت من الفرصة المتاحة حاليا، أم أنها لا تزال تسير على "طمام المرحوم"، أو بالحد الأدنى تعمل على ردات الفعل الاقتصادية؟
قبل أي أمر آخر، علينا الاعتراف أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ليس عيباً، فالعالم كله يقوم على التلاقح الثقافي والتبادل المعرفي، وكما استفادت دول الخليج من النهضة الكويتية في زمن مضى، وطورتها، علينا الاستفادة من تجارب تلك الدول، لا سيما أن النمط الاقتصادي مشابه، فكلنا دول نفطية، لكن الفرق أن البعض عرف كيف يوظف الثروة لتكون قوة له في المستقبل، بينما الآخر لا يزال يعيش على المكاسب الموقتة منها.
قلنا في مناسبة سابقة إن استقبالات صاحب السمو للفعاليات الاقتصادية والمالية الدولية تؤسس لمرحلة جديدة، لأن القيادة السياسية تدرك أنها ضرورة لا يمكن إهمالها، وهذا لا شك يعني عمل الوزارات بكل طاقتها من أجل ترجمة ذلك واقعاً، أكان في المالية، أو التجارة، أو الداخلية، أو البلدية، وغيرها من الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، فالانفتاح على الآخر ليس ترفاً بل ضرورة، وكذلك إفساح المجالات كافة لتشجيع الاستثمار المحلي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وليس إصدار قرارات تعرقل النشاط المحلي الصناعي والتجاري والخدماتي والزراعي، فهي تنفر الأجنبي، أيضاً.
لذا، ما الذي يمنع من تبسيط الإجراءات كافة، والإفساح في المجال للاستثمار المحلي كي يكون فاعلاً أكثر في الحركة الاقتصادية، ومنح إقامات طويلة الأمد للمستثمرين، وغيرها من الإجراءات التي عززت الاقتصاد في دول الخليج الأخرى؟
أخيراً، إن أي إعاقة للاستثمار المحلي، أو للمسار السياسي المحلي أيضاً، ينظر إليه القادم للاستثمار في الكويت بشيء من الريبة والتردد.